إشـكالية تعريف العلمانية
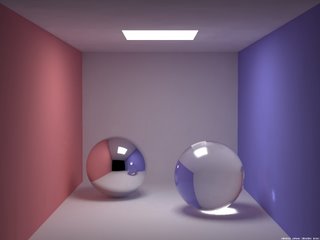
العلمانية: إشكالية التعريف
من أهم المصطلحات في الخطاب التحليلي الاجتماعي والسياسي والفلسفي الحديث في الشرق والغرب مصطلح «العلمانية». ويظن كثير من الناس أن مصطلحاً مهماً بهذه الدرجة لابد أن يكون واضحاً تمام الوضوح، محدد المعاني والمعالم والأبعاد. وهذا أمر بعيد كل البُعد عن الواقع. وسنحاول في مداخل هذا الباب أن نبيِّن بعض الأسباب والإشكاليات التي أدَّت إلى هذا الوضع، وسنتناول كل إشكالية في مدخل مستقل.
1 ـ إشكالية العلمانيتين: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة.
2 ـ شيوع تعريف العلمانية باعتبارها «فصل الدين عن الدولة»، وهو ما سطَّح القضية تماماً، وقلَّص نطاقها.
3 ـ تصوُّر أن العلمانية «مجموعة أفكار وممارسات واضحة» الأمر الذي أدَّى إلى إهمال عمليات العلمنة الكامنة والبنيوية.
4 ـ تصوُّر العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آخذة في التحقق.
إشكالية العلمانيتين: علمانية جزئية وعلمانية شاملة
لعل من أهم الأسباب التي أدَّت إلى اختلال مصطلح «علمانية» ما نسميه «إشكالية العلمانيتين». وجوهر هذه الإشـكالية أن مصطـلح «علمانية» (سواء في الخطاب التحليلي الغربي أم العربي) يشير في واقع الأمر إلى أكثر من مدلول. ويمكننا تَخيُّل مُتصل من المدلولات في أقصى أطرافه ما نسميه «العلمانية الجزئية»، وفي الطرف الآخر ما نسميه «العلمانية الشاملة» وتتمازج المدلولات فيما بينها وتختلط وتتشابك وتتشابه وتتصارع.
1 ـ العلمانية الجزئية:
هي رؤية جزئية للواقع (برجماتية ـ إجرائية) لا تتعامل مع الأبعاد الكلية والنهائية (المعرفية) ومن ثم لا تتسم بالشمول. وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة وربما الاقتصاد، وهو ما يُعبَّر عنه بعبارة «فصل الدين عن الدولة». ومثل هذه الرؤية الجزئية تَلزَم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة. كما أنها لا تنكر وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية وربما دينية أو وجود ماورائيات وميتافيزيقا. ولذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو أخلاقية. كما أنها رؤية محددة للإنسان، إلا أنها تراه إنساناً طبيعياً مادياً في بعض جوانب من حياته (رقعة الحياة العامة) وحسب، وتَلزَم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأخرى من حياته. ويمكن تسمية العلمانية الجزئية «العلمانية الأخلاقية» أو «العلمانية الإنسانية».
2 ـ العلمانية الشاملة:
رؤية شاملة للواقع ذات بُعد معرفي (كليّ ونهائي) تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدين والمطلقات والماورائيات (الميتافيزيقية) بكل مجالات الحياة. فإما أن تُنكر وجودها تماماً في أسوأ حال، أو تهمِّشها في أحسنه، وترى العالم باعتباره مادياً زمانياً كل ما فيه في حالة حركة ومن ثم فهو نسبي. ويتفرع عن هذه الرؤية منظومات معرفية (الحواس والواقع المادي مصدر المعرفة) وأخلاقية (المعرفة المادية المصدر الوحيد للأخلاق) وتاريخية (التاريخ يتبع مساراً واحداً وإن اتبع مسارات مختلفة فإنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى نفس النقطة النهائية) ورؤية للإنسان (الإنسان ليس سوى مادة، فهو إنسان طبيعي/مادي) والطبيعة (الطبيعة هي الأخرى مادة في حالة حركة دائمة). كل هذا يعني أن كل الأمور في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير تاريخانية زمنية نسبية. ويمكن تسمية العلمانية الشاملة «العلمانية الطبيعية/المادية» أو «العلمانية العدمية». والتعريف الأول هو التعريف الشائع بين معظم الناس والدارسين وهو الذي على أساسه يتصورون أنهم يديرون حياتهم. ولا يتبنَّى التعريف الثاني سوى بعض الفلاسفة والمتخصصين. ومع هذا، يختلط التعريفان دائماً ويتشابكان، فتظهر تعريفات متنوعة مختلفة في درجات شمولها وجزئيتها، ويُشار لها جميعاً بكلمة «علمانية» دون تحديد أو تمييز. وهذا هو جوهر إشكالية العلمانيتين. إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة »فصل الدين عن الدولة» ترجمة للعبارة الإنجليزية «سيباريشن أوف تشيرش آند ستيت separation of church and state»، وهي أكثر تعريفات العلمانية شيوعاً في العالم، سواء في الغرب أو في الشرق. وهي عبارة تعني حرفياً «فصل المؤسسات الدينية (الكنيسة) عن المؤسسات السياسية (الدولة)». والعبارة تحصر عمليات العلمنة في المجال السياسي وربما الاقتصادي أيضاً (رقعة الحياة العامة) وتَستبعد شتى النشاطات الإنسانية الأخرى، أي أنها تشير إلى العلمانية الجزئية وحسب. ونحن نذهـب إلى أن ثمة فـصلاً حتـمياً نسـبياً للـدين والكهنوت عن الدولة في كل المجتمعات الإنسانية تقريباً، إلا في بعض المجتمعات الموغلة في البساطة والبدائية حيث نجد أن رئيس القبيلة هو النبي والساحر والكاهن (وأحياناً سليل الآلهة) وأن طقوس الحياة اليومية طقوس دينية كما هو الحال في العبادة اليسرائيلية قبل ظهور العبادة القربانية المركزية. أما في المجتمعات الأكثر تركيباً، فإن التمايز يبدأ في البروز. وحتى في الإمبراطوريات الوثنية التي يحكمها ملك متأله، فإن ثمة تمايزاً بين الملك المتأله وكبير الكهنة وقائد الجيوش! فالمؤسسة الدينية لا يمكن أن تتوحد بالمؤسسة السياسية في أي تركيب سياسي حضاري مركب، تماماً مثلما يستحيل أن تتوحد مؤسسة الشرطة الخاصة بالأمن الداخلي بمؤسسة الجيش الموكل إليها الأمن الخارجي، ولا أن تتوحد المؤسسة التعليمية بالمؤسسة الدينية. وفي العصور الوسطى المسيحية، كانت هناك سلطة دينية (الكنيسة) وأخرى زمنية (النظام الإقطاعي). بل داخل الكنيسة نفسها، كان هناك من ينشغل بأمور الدين وحسب ومن ينشغل بأمور الدنيا. وحينما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) "أنتم أعلم بأمور دنياكم"، فهو في واقع الأمر يقرر مثل هذا التمايز المؤسسي (فالقطاع الزراعي، حيث يمكن أن يؤبر المرء أو لا يؤبر حسب مقدار معرفته العلمية الدنيوية وحسب ما يمليه عليه عقله وتقديره للملابسات، متحرر في بعض جوانبه من المطلقات الأخلاقية والدينية). بل إن الجهاد نفسه ينطوي على مثل هذه الجوانب. قال ابن إسحق: "فخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يبادره إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به". قال ابن إسحق: "فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن منذر بن الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل.. أمنزلاً أنزلكه الله ليـس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يارسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغوِّر ماءه من القُلب، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون". فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لقد أشرت بالرأي". وثمة تمييز هنا بين الوحي (الذي لا يمكن الحوار بشأنه) وبين الحرب والخديعة (أي آليات إدارة المعركة العسكرية التي تخضع لإدراك ملابسات اللحظة)، أي أن ثمة تمايزاً بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية (ومما له أعمق الدلالة أن المسلمين كسبوا هذه المعركة). ومع تَزايُد تركيبية الدولة الإسلامية (مع الفتوحات والمواجهات)، تزايد التمايز بين المؤسسات وتَزايَد الفصل بينها. وغني عن القول أن الكهنوت (من منظور النموذج الإسلامي) لا يمكنه أن يلعب دوراً أساسياً، فعملية التفسير هي عملية اجتهادية وباب الاجتهاد مفتوح أمام الجميع ولا عصمة لبشر. ومن ثم، فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على المجتمعات العلمانية بأية حال وإنما هي عملية موجودة في معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال. ولذا، يتحدث بعض أصحاب هذا التعريف عن غياب التَعارُض في واقع الأمر بين العلمانية والتدين وأن بإمكانهما التعايش معاً. وهو أمر ممكن بالفعل إذا كان المعنى هو مجرد تمايز المجال السياسي عن المجال الديني وإبعاد رجال الدين والكهنوت عن مؤسـسات صنع القرار السـياسي. وأعتقد أن كثيراً ممن يتصورون أنهم أعداء للعلمانية سيقبلون هذا الفصل أو التمايز، إذا ما تأكدوا أن القيمة الحاكمة والمرجعية النهائية للمجتمع (وضمن ذلك مؤسسات صنع القرار) هي القيمة المطلقة (أخلاقية ـ إنسانية ـ دينية) وليس صالح الدولة أو المصالح الاقتصادية أو أية معايير نسبية أخرى، أي أن من الممكن أن يقبلوا بعلمنة المجال السياسي طالما كانت المرجعية النهائية مرجعية متجاوزة للدنيا وللرؤية النفعية المادية التي تجعل الطبيعة/المادة المرجعية الوحيدة. ولكن هذه العلمانية الجزئية (المرتبطة بالمراحل الأولى لتطور العلمانية الغربية) تراجعت وهُمِّشت إذ تصاعدت معدلات العلمنة بحيث تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا وأصبحت العلمنة ظاهرة اجتماعية كاسحة، وتحولاً بنيوياً عميقاً يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة وعملية التنظيم الاجتماعي (الرأسمالي والاشتراكي) ويتجاوز أية تعريفات معجمية وأية تصورات فكرية قاصرة محدودة، فلم تَعُد هناك رقعة للحياة العامة مستقلة عن الحياة الخاصة. فالدولة العلمانية والمؤسسات التربوية والترفيهية والإعلامية وصلت إلى وجدان الإنسان وتغلغلت في أحلامه ووجهت سلوكه وعلاقته بأعضاء أسرته النووية، ولم يعد من الممكن الحديث عن فصل هذا عن ذاك. بل إننا يمكننا أن نتحدث لا عن «فصل الدين عن الدولة» وإنما عن «هيمنة الدولة على الدين». ومن ثم أصبحت المقدرة التفسيرية والتصنيفية لنموذج العلمانية الجزئية ضعيفة إلى أبعد حد وأصبح مصطلح علمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة دالاً يقصر عن الإحاطة بمدلوله أي ظاهرة العلمانية في شمولها وتركيبيتها. ومع هذا تم الاحتفاظ به واستمر شيوعه حتى بعد ظهور بعض التعريفات الأخرى الأكثر شمولاً. ولذا اكتسب مصطلح (العلمانية) خاصية جيولوجية تراكمية فحين يظهر تعريف جديد يُضاف إلى التعريفات السابقة ويستمر إلى جوارها دون أن يحاول أحد صياغة كل التعريفات في نموذج واحد شامل ومركب له مقدرة تفسيرية عالية. وقد أدَّى هذا إلى أن الحوار بشأن العلمانية أصبح مُشوَشاً بل مستحيلاً إذ يستخدم المتحاورون نفس المصطلح (علمانية) ولكن كل واحد منهم يُسقط عليه معنى مختلفاً ويراه في إطار مرجعية مختلفة. إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها مجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة محددة يتصوَّر البعض أن عمليات العلمنة عمليات اجتماعية وسياسية وفكرية، وأنها تتم من خلال مخطط ثقافي مسبق ومن خلال آليات وممارسات واضحة (مثل نقل الأفكار وإشاعة الإباحية والذهاب إلى الشواطئ العرايا) يمكن تحديدها ببساطة ويمكن تبنيها أو رفضها بشكل واع.،مثل هؤلاء عادةً ما يتصورون أن التدين هو الآخر مجموعة من الممارسات البسيطة الواضحة (مثل الذهاب إلى المسجد والصوم). وبالتالي فإن إشاعة العلمنة يعني (من هذا المنظور) إصدار تشريعات سياسية معينة والحض على أفكار بعينها، وهكذا. وللتحقق من معدلات العلمنة (والتدين) في مجتمع ما، فإن الباحث الذي يؤمن بمثل هذه الرؤية يتناول عمليات العلمنة الواضحة وآلياتها المباشرة ويبحث عن المؤشرات المحسوسة الظاهرة، فإن وجدها صنَّف المجتمع باعتباره مجتمعاً علمانياً وإن لم يجدها فهو مجتمع إيماني. ومن نفس المنظور الاختزالي تُناقَش العلمانية في إطار نقل الأفكار والتأثير والتأثر، فيُنظر إلى العلمانية على أنها مجموعة من الأفكـار الغربية صاغها بعـض المفكرين الغربيين، وقام بعض الناس بتطبيقها، ثم قلدهم البعض الآخـر، ثم اتسع نطاق التقليد والممارسات تدريجياً وانتشرت العلمانية. وفي العالم العربي يسود تصوُّر مفاده أن بعض المفكرين العرب (وخصوصاً مسيحيي الشام) قام "بنقل" الأفكار العلمانية الغربية وأنهم "تسببوا" بذلك في نشر العلمانية في بلادنا. بل يذهب البعض إلى أن عملية نقل وتطبيق الأفكار العلمانية تتم من خلال مخطط محكم (أو ربما مؤامرة عالمية يُقال لها أحياناً «صليبية» أو «يهودية» أو «غربية»). ويذهب دعاة هذه الرؤية إلى أن الأفكار العلمانية ظهرت في أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية باعتبارها عقيدة تفصل الدين عن الدولة، وبسبب فساد الكنيسة وسطوتها ولولا فساد الكنيسة لما ظهرت العلمانية. فالعلمانية من ثم ظاهرة مسيحية مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالغرب المسيحي، لا علاقة للإسلام والمسلمين بها. ولذا تصبح مهمة من يود الحرب ضد العلمانية هي البحث عن الأفكار العلمانية والممارسات العلمانية (الواضحة) وعن القنوات التي يتم من خلالها نقل الأفكار والانغماس في الممارسات العلمانية. ومهمة من يبغى الإصلاح هي ببساطة استئصال شأفة هذه الأفكار والممارسات، يساعده في هذا البوليس السري والمخابرات العامة. ولا يمكن أن نقلل أهمية الأفكار والممارسات العلمانية الواضحة، فهي تساعد ولا شك على تَقبُّل الناس للمُثُل العلمانية، وخصوصاً إذا أشرف على عملية نقل الأفكار وفرض الممارسات مؤسسة ضخمة مثل الدولة المركزية. ولكن مع هذا يظل تَصوُّر العلمانية باعتبارها مجموعة أفكار وممارسات واضحة تصوراً ساذجاً، ويشكل اختزالاً وتبسيطاً لظاهرة العلمانية وتاريخها، وللظواهر الاجتماعية على وجه العموم.
وهذه الرؤية تتجاهل بعض الحقائق البديهية والبسيطة:
1 ـ النماذج الطبيعية/المادية موجودة بشكل كامن في أي مجتمع بشري، ومكوِّن ضروري وأساسي في الوجود الإنساني. وعلى المستوى الفكري، يمكن القول بأن الأفكار العلمانية كامنة في أي مجتمع على وجه الأرض (ومنها المجتمعات الإسلامية بطبيعة الحال)، فإغراء التفسيرات المادية والنزعة الجنينية التي تُعبِّر عن نفسها في الرغبة في التحـكم الكامـل وفي التخلي عن الحـدود وعن المسئولية الخُلقية جزء من النزعة العامة الموجودة في النفس البشرية. وهي نزعة تُعبِّر عن نفسها في النزوع نحو الحلولية الكمونية الواحدية. وهذا يعني أن الاتجاه نحو العلمنة والواحدية المادية إمكانية كامنة في إنسانيتنا المشتركة، ومن ثم في المجتمعات الإسلامية، التي تُوجَد فيها نزعات حلولية كمونية واحدية متطرفة، وفي أي مجتمع إنساني.
2 ـ أية جماعة إنسانية، مهما بلغ تدينها وتَمسُّكها بأهداب دينها (وضمن ذلك الأمة الإسلامية) لابد أن تتعامل في كثير من الأحيان مع الزمان والمكان والطبيعة والجسد من خلال إجراءات زمنية صارمة دون أي تجاوز. فعملية بناء بيت عبادة يتطلب اختيار عمال يتسمون بالكفاءة في أدائهم المهني، ونحن لا ننظر كثيراً في أدائهم الأخلاقي أو في معتقداتهم الدينية إلا بمقـدار تأثير هذا في أدائهم المهني، أي أن عملية اختيار العمال تخضع لمعايير زمنيـة. ومع هذا، يظل الهدف النهائي من عملية بناء بيت العبادة إقامة الشعائر وليس الربح المادي، فالبناء وسيلة وليس غاية. وعناصر العلمنة موجودة في أي مجتمع، في الهامش وفي حالة كمون، ويمكن أن تنتقل من الهامش إلى المركز ومن الكمون إلى التحقق، إن ظهرت اللحظة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية المواتية وساد الجو الفكري المناسب.
3 ـ والسلوك الإنساني يبلغ الغاية في التركيب وما يحدده ليس العوامل الواضحة والبرامج المحددة وحسب. فدور العناصر الكامنة غير الواضحة غير الواعية في تشكيل السلوك الإنساني قوي، بل إنها في معظم الأحيان تكون أقوى كـثيراً من العـناصر الواضحـة التي يستطيع الإنسان أن يمارس إرادته ضدها، فيتحاشاها أو يحاصرها أو يحيدها.
ومن ثم فدراسة ظاهرة العلمانية باعتبارها مجموعة من الأفكار المحددة والممارسات الواضحة، تتجاهل الكثير من جوانبها وبالتالي تفشل في رصدها. ومصطلح «علمانية» الذي لا يشير إلا إلى هذه الجوانب هو دال قاصر عن الإحاطة بمدلوله. فالعلمانية ثمرة عمليات كثيرة متداخلة بعضها ظاهر واضح والآخر بنيوي كامن، وتشمل كل جوانب الحياة، العامة والخاصة، والظاهرة والباطنة، وقد تتم هذه العمليات من خلال الدولة المركزية، بمؤسساتها الرسمية، أو من خلال قطاع اللذة من خلال مؤسساته الخاصة، أو من خلال عشرات المؤسسات الأخرى (ومنها المؤسسات الدينية)، أو من خلال أهم المنتجات الحضارية أو أتفهها.
إشكالية تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آخذة فى التحقق
يظن كثير من الناس أن العلمانية فكرة ثابتة أو مخطط محدد ، بينما هي في الواقع متتالية نماذجية تتحقق تدريجياً في الزمان، ومن خلال عمليات علمنة متصاعدة آخذة في الاتساع. ومن ثم نجد أن معدلات العلمنة في المراحل الأولى لمتتالية العلمنة تختلف عن نظيرتها في المراحل الأخيرة. كما أن المجالات التي تتم علمنتها في المراحل الأولى محدودة ولا تتجاوز بعض جوانب رقعة الحياة العامة. ولكن نطاق العلمنة يبدأ في الاتساع وتزداد حدته فتغطي مزيداً من المجالات إلى أن تغطي معظم المجالات أو تمتد لتغطيها جميعاً، ولا فرق في هذا بين رقعة الحياة العامة ورقعة الحياة الخاصة. ولكن مصطلح «علمانية» قد عُرِّف في المراحل الأولى في متتالية العلمنة قبل أن تكتمل حلقاتها وقبل أن تتحقق بعض إمكاناتها وقبل أن تتبلور نتائجها على أرض الواقع والتاريخ. ولذا نجد هناك حديثاً عن فصل الدين عن الدولة، وعدم التدخل في حياة الإنسان الخاصة واحترام الدين والقيم (وهذه جميعاً من سمات العلمانية الجزئية). وما حدث على أرض الواقع قد تجاوز ذلك تماماً، الأمر الذي جعل الدال «علمانية» قاصراً عن الإحاطة بمدلوله. ففي المراحل الأولى من تَطوُّر العلمانية يُلاحَظ أن الدولة القومية لم تكن قد طوَّرت بعد مؤسساتها الأمنية والتربوية (الإرشادية والتعليمية)، فكانت هي نفسـها دولة جزئية لا تتسـم بالشـمولية. ولم تكن وسائل الإعلام قد بلغت بعد ما بلغته من قوة وسطوة، ولم يكن قطاع اللذة قد بلغ بعد ما بلغه من مقدرة على الإغواء. وهذا يعني أن كثيراً من قطاعـات حياة الإنسـان كانت بمنأى عن عمليات العلمنة، التي كانت في غالب الأمر محصورة في عالمي الاقتصاد والسياسـة. وإذا كانت علمنة ظاهرة ما هو استيعابها في إطار المرجعية المادية الكامنة وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية، فإن علمنة الاقتصاد تعني أن يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية ذاته، أي أن يصبح نشاطاً اقتصادياً محضاً (ويخضع كل شيء لآليات السوق غير الإنسانية) ويصبح النشاط السياسي سياسياً (فتظهر الدولة المطلقة التي تود أن تُخضع كل شيء لغاياتها). ورغم عمليات العلمنة هذه، ورغم حدتها، فقد ظل الإنسان بمنأى عنها. فلم تكن إعادة صياغته قد تمت بحيث يصبح المواطن الرشيد المُدجَّن الذي يدين بالولاء للدولة وحسب، أو الإنسان الاقتصادي الجسماني، الذي يتحرك حسب ما يصله من تعليمات رشيدة من الدولة أو وسائل الإعلام، ويُغيِّر قيمه حسب ما يصله من تعليمات. ولأن عملية إعادة صياغته تمت إلى حدٍّ ما بشكل براني، فإنه كان حراً تماماً من الداخل يعيش داخل تراثه الثقافي وعقائده الدينية المتوارثة. لقد ظل الإنسان قائماً في مركز الكون يُشكل نقطة مطلقة، غير مُستوعَبة في النظام الطبيعي المادي، يمثل ثغرة معرفية فيه ونقطة مرجعية متجاوزة تصلح أساساً لتحديد الغاية والمعيارية. وقد شكَّلت هذه النقطة أساساً فلسفياً قوياً لظهور فلسفات إنسانية تحوي مطلقات، كما أنها كنقطة متجاوزة للنظام الطبيعي يمكن أن تُشير إلى الماورائيات (الإنسان غير الطبيعي والإنسان الرباني)، وإلى الرؤية الإيمانية (في هذه الحالة المسيحية). وقد أدَّى هذا إلى انقسام الحياة إلى قسمين: حياة عامة خاضعة للمرجعيات المادية، وأخرى خاصة متحررة منها. لكل هذا، لم تقض المسيحية نحبها على الفور مع ظهور الفكر العلماني، بل استمرت بمطلقاتها الدينية والأخلاقية والإنسانية في ضمائر الناس ووجدانهم وعقولهم، بل في بعض المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة. وقد لعبت النزعة الإنسانية الهيومانية دوراً مماثلاً، فقد استوردت بعض مطلقات العقيدة المسيحية وعلمنتها بشكل سطحي وجعلتها مطلقات إنسانية واحتفظت بها داخل منظومتها الطبيعية المادية (دون أن تكون لها أية علاقة فلسفية حقيقية بهذه المنظومة). وسواء أكانت منظومة إيمانية أم إنسانية، فقد احتفظت بمرجعية متجاوزة تخلق ثنائية. واستناداً إلى هذا، تم تطوير منظومات معرفية وأخلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية. بهذه الطريقة، زوَّدت المسيحية والنزعة الهيومانية (والاشتراكية الإنسانية) الإنسان الغربي بالإطار الميتافيزيقي والقيمي والكلي وبضمير وهدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية تماماً يمكنه من خلالها إدارة حياته الشخصية بل بعض جوانب حياته الاجتماعية، دون السقوط في النسبية والعدمية الكاملة التي تجعل هذا الاستمرار مستحيلاً أو مكلفاً لأقصى درجة. وبهذه الطريقة، تَمكَّن المجتمع العلماني من تحاشي مواجهة ما يُسمَّى «المشكلة الهوبزية»، أي مشكلة محاولة تأسيس مجتمع يدور في إطار المرجعية المادية الكامنة، كل فرد فيه يحاول أن يحقق مصلحته الشخصية المادية (منفعته ولذته) ولا يلتزم بأية مرجعية أخلاقية أو إنسانية متجاوزة، بحيث يصبح الإنسان ذئباً لأخيه الإنسان وتصبح كل العلاقات تعاقدية. إن ما حدث هو أن بعض مجالات الحياة العامة وحسب تمت علمنتها، وظلت الحياة الخاصة حتى عهد قريب جداً محكومة بالقيم المسيحية أو بالقيم العلمانية التي تستند في واقع الأمر إلى مطلقات إنسانية أخلاقية، أو مطلقات مسيحية متخفية. فكأن الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة في مجتمع علماني داخل إطار المرجعية المادية الكامنة (علمانية شاملة)، ولكنه كان يحلم ويحب ويكره ويتزوج ويموت داخل إطار المرجعية المتجاوزة المسيحية أو شبه المسيحية الإنسانية (علمانية جزئية). ولذا، كان من الممكن أن نجد أستاذاً للفلسفة يُدرِّس فلسفة إباحية عدمية في الجامعة (حياته العامة) ولكنه لا يسمح لابنته أن تعيش مع شخص دون زواج، بل يذهب إلى الكنيسة كل أحد. وكان من الممكن أن نجد رأسمالياً يؤمن بشكل كامل بقيم السوق النفعية ولكنه يدافع بشراسة عن مؤسسة الأسرة، فتمت عملية الضبط الاجتماعي الخارجية من خلال المرجعية المادية الكامنة، وتمت عملية الضبط الاجتماعي الداخلية من خلال المنظومة المسيحية أو المنظومة الهيومانية. ولعل هذا هو أساس الزعم العلماني الخاص باستقلال الحياة العامة التي تحكم قيم الدولة العلمانية عن الحياة الخاصة التي تتركها الدولة العلمانية للفرد يمارس فيها حريته الدينية وهويته الإثنية. فالفرد في الغرب كان بالفعل حراً في حياته الخاصة لا لأن الدولة (وكذلك قطاع اللذة) قد أحجمت عن التدخل فيها (و"استعمارها" على حد قول هابرماس) وإنما لأن المسيحية والمطلقات الهيومانية استمرت في وجدانه. ولم يكن بوسع الدولة العلمانية أو وسائل الإعلام وقطاع اللذة التغلغل في هذا المجال، ومن ثم تمت إعاقة المتتالية العلمانية عن التحقق لتظل بالأساس علمانية جزئية.ولكن الأمور تغيَّرت إذ تتابعت حلقات المتتالية بخطى أخذت تتزايد في السرعة (إلى أن اكتملت في منتصف الستينيات). فقد ازدادت الدولة العلمانية قوة وتغولت وأصبحت الدولة التنين التي تنبأ بها هوبز وأحكمت بمؤسساتها الأمنية قبضتها على الفرد من الخارج. كما أحكمت مؤسساتها التربوية قبضتها عليه من الداخل، تساعدها في ذلك وسائل الإعلام وقطاع اللذة اللذان تمدَّدا وتغولا بطريقة تفوق تغوُّل الدولة وتنينيتها. واتسع نطاق العلمنة وتخطى عالم السياسة والاقتصاد ووصل إلى عالم الفلسفة (فلسفة الاستنارة والعقلانية المادية)، ثم عالم الوجدان. وأخيراً إلى عالم السلوك اليومي، أي أن الإنسان تم ترشيده وتدجينه تماماً من الداخل والخارج، ولم يَعُد هناك أي أثر للمرجعية المتجاوزة، ولم يعد هناك أي أساس لأية معيارية، إذ أصبح لكل مجال من مجالات الحياة معياريته (غير الإنسانية) المستقلة. فتآكلت بقايا القيم المسيحية والقيم الإنسـانية الهيومانية ومات الإله (على حد قول نيتشـه) وظهرت الفلسـفات المعادية للإنسـان، مثل البنيوية وما بعد الحداثة، التي تُنكر على الإنسان المقدرة على التجاوز. وقد حدث الشيء نفسه للمنظومة الاشتراكية. فبدلاً من التأرجح بين المرجعية المتجاوزة (الإنسان والقيم الإنسانية المطلقة) والمرجعية الكامنة (وسائل الإنتاج ـ حركة المادة ـ إشباع الحاجات والملذات المادية)، تَغوَّلت الدولة السوفيتية وتَغوَّل الحزب ووسائل الإعلام وقطاع اللذة وزاد التركيز على الاشتراكية العلمية في صفوف النخب الحاكمة الاشتراكية، وأصبح اللحاق بالغرب الذي يدور في إطار الطبيعة/المادة (وليس تحقيق إمكانات الإنسان المتجاوزة) هو المثل الأعلى. فتم ترشيد الإنسان وتدجينه، وبدأ يختفي تدريجياً أي إحساس بمطلقات متجاوزة (ظلال الإله) إلى أن اختفى الإنسان ومات الإله وسادت النسبية والنفعية. ثم تتالت الحلقات وبعد أن تمت السيطرة على الإنسان تماماً وأصبح مذعناً لقانون الطبيعة والأشياء وسقط تماماً في دوامة الصيرورة والنسبية، اتسع نطاق الصيرورة ليبتلع الطبيعة/المادة نفسها، كمصدر للمعيارية ومركز للعالم، ودخل العالم عصر ما بعد الحداثة والسيولة الشاملة واللامعيارية. والفرق بين ما نسميه «العلمانية الجزئية» وما نسميه «العلمانية الشاملة» هو في واقع الأمر الفرق بين مراحل تاريخية لنفس النموذج؛ حلقات في نفس المتتالية. ففي المراحل الأولى للمتتالية تتسم العلمانية بالجزئية حينما يكون مجالها مقصوراً على المجالين الاقتصادي والسياسي، حين يكون هناك بقايا مطلقات مسيحية وإنسانية، وحين تتسم الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن اقتحام (أو استعمار) كل مجالات الحياة، وحين يكون هناك معيارية إنسانية أو طبيعية/مادية. ولكن، في المراحل الأخيرة، ومع تزايد قوة الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة وتَمكُّنه من الوصول إلى الفرد وإحكام القبضة عليه من الداخل والخارج، ومع اتساع مجال عمليات العلمنة وضمور المطلقات واختفائها وتهميش الإنسان وسيادة النسبية الأخلاقية ثم النسبية المعرفية، تظهر العلمانية الشاملة. وما طرحناه هو متتالية نماذجية، أي متتالية مجردة. وتاريخ العلمنة في العالم الغربي يختلف عن تاريخ العلمنة في العالم الثالث. بل يختلف تاريخ العلمنة من بلد إلى بلد وداخل كل تشكيل حضاري. فتاريخ العلمنة في إنجلترا يختلف عن تاريخ العلمنة في الولاياـت المتحـدة وروسيا القيصـرية وألمانيـا النازيـة، تمامـاً كمـا يختلف تاريـخ العلمـنة في اليـابان عنـه في الهنـد أو فـي تركـيا. كمـا أن هناك دائماً حركـات مقـاومة واحتـجاج. فرغم أننا دخلنا مرحلة السيولة الشاملة إلا أن هناك جيوباً إنسانية (هيومانية) ومسيحية لا تزال تحاول تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة، وهناك عقلانيون ماديون يحاولون تأكيد الطبيعة/المادة باعتبارها مصدراً للمعيارية. ولكن، مع هذا، يظل لهذه المتتالية مقدرة تفسيرية عالية إذ يمكن من خلالها أن ندرك الفرق بين المجتمع الإنجليزي في منتصف القرن الثامن عشر والمجتمع الإنجليزي في أواخر القرن العشرين، فكلاهما مجتمع علماني ولكن شتان بينهما، فالأول تسوده العلمانية الجزئية، حيث الفرد فيه لم يخضع بعد للمرجعية المادية الكامنة، وأما الثاني فهو مجتمع تسود فيه العلمانية الشاملة وتسيطر عليه الواحدية المادية تماماً ثم السيولة الشاملة. وهذا هو أيضاً الفرق بين المجتمع المصري في أوائل الخمسينيات والمجتمع المصري في أواخر التسعينيات. وهو الفرق بين الخطاب العلماني في المراحل الأولى للعلمنة والخطاب العلماني في المراحل الأخيرة. وهو الفرق بين الدولة السوفيتية والدولة الأمريكية بعد إعلان الثورة (الأمريكية والبلشفية) مباشرةً والدولتان السوفيتية والأمريكية في الثمانينيات. ولا يمكن القول بأن كل فرد يمر في حياته من خلال المتتالية العلمانية والانتقال من الجزئي إلى الكلي والشامل (فهذه عملية اجتماعية تاريخية). ومع هذا لا يتبنى الفرد النموذج السائد في مجتمعه بقضه وقضيضه، فمعظم البشر يعيشون حياتهم المتعينة مستخدمين أكثر من نموذج وأكثر من مرجعية، بعضها قد يكون متناقضاً تماماً مع البعض الآخر. فيمكن أن يعلمن الإنسان حياته الاقتصادية والسياسية بشكل كامل ويُخضعها للمرجعيات والمعايير والمنظومات العلمانية الشاملة، وفي الوقت نفسه يرفض (بشكل واع أو غير واع)، علمنة سلوكه أو حياته الشخصية بنفس الدرجة (أو لا يَجسُر على ذلك) ويرفض إخضاعها لنفس المرجعية والمعايير والمنظومات التي طَبَّقها على حياته العامة، أي أنه في حياته السياسية والاقتصادية يخضع للعلمانية الشاملة والواحدية المادية ويصبح شيئاً بين الأشياء، وفي حياته الخاصة يدور في إطار مرجعية متجاوزة ولذا فإنه يظل بشراً حر الإرادة ذا حس خُلقي قوي يعي ثنائيات المطلق والنسبي، أي يدور في إطار العلمانية الجزئية.
موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري الجزء الرابع، الباب الاول.


